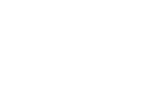رجعت صفیة إلی أخوتها «أعمام النبی» و أخبرتهم بصدق الخبر، و استولت الفرحة علی أعمام النبی، فرحة ممزوجة بالتعجب و الدهشة و الذهول.
فإن خدیجة خطبها الأمراء و أشراف العرب فرفضت و لم توافق، إذ انها لم ترهم لها أکفاءً، فما الذی دعاها إلی انتخاب هذا الزوج الفقیر الذی لا یملک من حطام الدنیا تبراً، و لا من الأرض البسیطة شبراً؟
یا للعجب العجاب!!
قام أعمام النبی و قصدوا دار خدیجة، و خطبوها من أبیها خویلد أو عمِّها، فامتنع ثم وافق بعد ذلک.
ثم لابدَّ من تقدیم مبلغ من المال صداقاً یلیق بمقام خدیجة، فکیف یمکن تحصیل هذا المال؟ و من أین؟ و من الذی یتبرع بالصداق؟
و إذا بالسیدة خدیجة تباغتهم مرة أخری، و تدفع إلی الرسول أربعة آلاف دینار هدیة، و تطلب منه أن یجعل ذلک المبلغ صداقاً لها و یقدِّمه إلی أبیها خویلد. و فی روایة: أن أباطالب هو الذی دفع الصداق من ماله.
إن کانت السیدة خدیجة تؤمن بالقیَم، و تضحَّی بالمادة فی سبیل تحصیل الشرف فإن أباها خویلد لم یکن یحمل هذه الفکرة، و کثیراً ما تجد التفاوت الکثیر بین ثقافة الأب و ابنه أو إبنته.
و هذا الاختلاف فی التفکیر موجود بین طبقات الناس، و حتی بین الأخ و أخیه، و الرجل و زوجته، و الأب و ما ولد.
کانت هذه البادرة نادرة عجیبة جداً، فلم یعهد أحد فی العرب أن المرأة تقدِّم الصداق لزوجها، فلا عجب إذا هاج الحسد بأبیجهل و قال: «یا قوم رأینا الرجال یمهرون النساء، و ما رأینا النساء یمهرون الرجال».
فیجیبه أبوطالب مغضباً: «مالک؟ یا لکع الرجال! مثل مُحمد یُحمل إلیه و یُعطی، و مثلک یُهدی و لا یُقبل منه»
أو قال: «إذا کانوا مثل ابن أخی هذا، طلبت الرجال بأغلی الأثمان و أعظم المهر، و إذا کانوا أمثالکم لم یزوَّجوا إلاَّ بالمهر الغالی».
و تمَّ الزواج المبارک المیمون علی أحسن ما یرام، و انتقل الرسول إلی دار السیدة خدیجة، فکانت خدیجة تشعر أنها فی أسعد أیام حیاتها إذ أنها و صلت إلی أغلی أمانیها و أحلی أحلامها.
و أنجبت السیدة خدیجة أولاداً ماتوا کلهم فی أیام الصغر، و أنجبت بنات أربع: زینب و أمکلثوم و رقیة و فاطمة الزهراء، و کانت فاطمة أصغرهنَّ سناً و أجلَّهنَّ شأْناً و أعظمهنَّ قدراً.
و هناک اختلاف بین المؤرخین و المحدّثین حول البنتین الأولیین، فقیل: إنهما لیستا من بنات النبی، و الصحیح أنهما من بناته و صلبه، و سیأتی الکلام حول ذلک فی المستقبل بالمناسبة بإذن اللهِ(1)
1) اقتطفنا تفاصیل زواج السیده خدیجه من بحارالانوار ج 16.